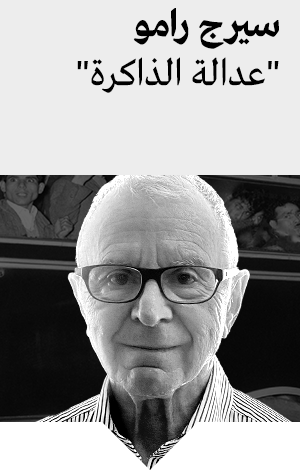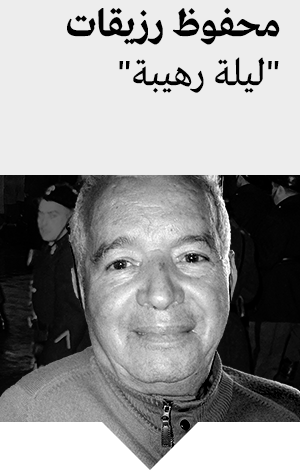"كانوا يصرخون. كانوا يئنون"
ولد سيرج رامو في ديسمبر/كانون الأول عام 1946 في بوخارست برومانيا. قبل نزول الستار الحديدي (بين أوروبا الشرقية والغربية - المحرر)، أخرجته من هناك مضيفة طيران ولم يكن يبلغ بعد من العمر تسعة أشهر. في حين استغرق الأمر من والديه ثلاث سنوات للوصول إلى باريس سيرا على الأقدام. استقبلته وقامت بتربيته أسرة فرنسية، وحصل على وضع لاجئ سياسي حتى بلغ العشرين من العمر قبل أن يتجنس بالجنسية الفرنسية. في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، وجد ذلك المراهق نفسه في وسط المظاهرات عند خروجه من محطة المترو في ساحة "إيتوال". فرأى كيف كانت الشرطة تسيء معاملة الجزائريين. أراد سيرج أن يدلي بشهادته عما رآه وما سمعه من هول الصدمة، حتى لا يهال التراب على هذه الأحداث. جراح الأسنان المتقاعد هذا حاصل على وسام الشرف والاستحقاق، وهو اليوم المندوب العام لجمعية المحاربين القدماء "تذكار من فرنسا". يعيش اليوم سيرج رامو في رومانيا.
"كان عمري وقتها 14 عاما، وكنت عضوًا في الكشافة. كنت أقطن عند جدتي في الدائرة 17 في باريس. وعندما أقفل راجعًا إلى الدار بعد دروس الكشافة، كنت أهبط في محطة مترو "إيتوال" لأستقل بعدها الحافلة العمومية. أعتقد أنها كانت رقم 52 وتوصلني إلى محطة "بون كاردينيه". عند خروجي من المترو وجدت نفسي في وسط مشهد درامي. لم أكن على علم بوجود مظاهرات. كنت يافعًا آنذاك ولم أكن أهتم بما يحدث من حولي. لو كنت أعرف أن الجزائريين قد دعوا لتنظيم مظاهرات لم أكن لأنزل من المترو في محطة "إيتوال".
كانت الساعة الخامسة بعد العصر، والتي يخيم فيها الظلام في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن ليس تماما. لم يكن هناك غير الرجال. وكانت الشرطة تتلقفهم بمجرد خروجهم من مطلع المترو وتوسعهم ضربًا. وكانوا يجبرونهم على الصعود في عربات الشرطة وذلك بوخزهم بالإبر. لقد هالني ما رأيته. وكانوا يصرخون ويئنون. لا زلت أذكر صرخات الألم، والعنف المفرط.
فابتعدت مسرعًا، لكني لم أكن أعدو حتى لا ألفت الأنظار إليَّ. كنت أعرف جيدًا أن الشرطة تشتبه في الأشخاص الذين يركضون من أمامها. أسرعت الخطى، كانت وجهتي هي محطة الحافلات، ولكن ليست الأولى. فقد ذهبت أبعد قليلًا من المعتاد.
كنت مصدوما تماما. في ذلك الزمن كنا معتادين على نوع معين من العنف. أكياس من الرمال لحماية أقسام الشرطة. كنت وقتها في مدرسة "جونسون دو سايي" الثانوية بالدائرة 16، وكان أمرًا عاديًا تفتيش الحقائب المدرسية. ففي يوم من الأيام، ذهبت إلى طبيب الأسنان مع جدتي في جادة "بون نوفيل"، وعلى بعد مترين فقط مني شاهدت رجلا يخرج مسدسا ويطلق رصاصة على رأس أحد الجزائريين.
كان هذا هو الجو السائد وقتها، ولكني لم أكن أتخيل للحظة أن يصدر ذلك عن الشرطة. في ذلك الزمان، كنا نحترم الشرطة والسلطات والزي الرسمي. وكان ذلك شيئا استعصى عليَّ فهمه.
كان عمي مستوردا للسجاد. وكان يعمل لديه في شركته عدد من المغاربة. وكانوا يضعون السجاجيد على أكتافهم ويدورون من بيت إلى بيت ليبيعوها. في تلك الأيام الدرامية التي شهدتها باريس كان العنف تجاههم مفرطا حقا. لم يكن موظفوه جزائريين ولكن الشرطة لم تجهد نفسها في التفريق بينهم. كان ذلك حقًا مخالفًا للقانون وتثبت من الهويات بناء على ملامح الوجه. وألقي أربعة أو خمسة من موظفيه في مياه نهر السين. حمدًا لله أنهم لم يقيدوا أيديهم. فقد نجحوا في السباحة والخروج ولكن أحدهم مات غرقًا. عرفت بذلك أن عددًا من المغاربة قد لاقوا حتفهم غرقًا بعد أن قيدت أيديهم. بإمكاني الآن الشهادة على العنف الرهيب الذي تعرضوا له ولا سيما على يد الدولة الفرنسية.
سمعت الأخبار في الراديو. وفهمت أنه كان هناك مظاهرة ممنوعة وأن مدير الأمن أصدر أوامره بالقيام بعمليات اعتقال مسبقة تجنبًا لمواجهة المتظاهرين وتفريقهم. ولكنهم لم يعطوا المزيد من التفاصيل. لم يكن هناك بالطبع حديث عن ذلك العنف غير المبرر. كانوا يقولون فقط إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص.
ولكنهم لم يكونوا مسلحين. فلو كانوا مسلحين لحدثت معارك بالتأكيد. فجميع من شاهدتهم كانت الشرطة توخزهم بالإبر حتى يصعدوا في الحافلات. فلو كانت معهم عصي كانوا قد دافعوا عن أنفسهم. كان هؤلاء الرجال شجعانًا حقًا لأنهم كانوا يعرفون أن المظاهرة محظورة. كانت هناك وفيات غير رسمية أكثر من الوفيات الرسمية المعلن عنها، ومعظمها غرقًا. وجرف معظمهم التيار فلم يدخلوا في الحسبان.
كان هناك وقتئذ نوع من سياسة الفصل العنصري. فلم يكن المغاربة يعيشون معنا في نفس الأحياء. وكان جلهم من الرجال الذين قدموا للعمل. وكان الجزائريون والمغاربة يعيشون في مساكن، فلم يكن قد وجدت بعد الضواحي العمالية. كانوا يعيشون عمليًا خارج المجتمع. كان هناك عالمان منفصلان.
عندما أفكر في الأمر الآن، أقول لنفسي ربما كان الفرنسيون خائفين من العمليات الإرهابية. وكان من يقف وراء العمليات الإرهابية منظمة "الحركة الوطنية الجزائرية" ضد "جبهة التحرير الوطني" والعكس بالعكس، وضد أقسام الشرطة أيضا.
أدركت كل ذلك عندما بلغت 17 عامًا. وبدأت في قراءة صحيفة "لوموند"، التي كانت تتحدث عن موريس بابون الذي قام بترحيل يهود بوردو. وعرفت وقتها أن الشرطة كانت تتبع أوامر مدير الأمن.
من وجهة نظري، إن الإنسان متوحش في الأساس. والشيء الوحيد الذي يكبله عن ارتكاب العنف هو القانون والحضارة. وإذا كان المسؤولون عن تطبيقه يقولون لنا إن جزءا منا لا يزال حرًا لذلك فإننا نقع بسهولة في براثن الوحشية. وهو ما رأيناه بأعيننا في جرائم الإبادة والبربرية النازية. إن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق رجال الشرطة هؤلاء الذين كانوا يقمعون المغاربة ولكن على رؤسائهم.
لقد نزع وسام الشرف من بابون بسبب ترحيله أطفال اليهود في بوردو وليس بسبب أحداث 1961. وكان دفاعه الوحيد عن نفسه بأنه كان يطيع أوامر رؤسائه. وكان الغريب في الأمر أن الجنرال ديغول، البعيد تماما عن العنصرية، قد عينه مديرًا للأمن. فهو منصب مهم، دولة داخل الدولة. وكان يعرف جيدًا أن بابون لم يكن يومًا مع المقاومة وإنما متعاون جبان مع النازيين.
وأعتقد أن عنف الشرطة لا يغتفر أيا كانت البلد التي يمارس فيها. والاعتراف بأن الذراع الحديدي للجمهورية ارتكب أخطاءً كان يمكن أن ينظر إليه بوصفه علامة على الضعف. كان ينبغي للتسلسل القيادي في قلب الشرطة أن يستنكر ذلك. وهو ما جرى مع حملة "فال ديف" التي استهدفت يهود فرنسا. في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول لم يسقط الآلاف من الضحايا لكنه مع ذلك يظل أمرًا لا يحتمل. لقد كانت الفكرة هي تخويف السكان المغاربة حتى لا يثوروا وأن تظل الجزائر فرنسية.
وهي صفحة مجهولة من التاريخ. وأنا أتكلم عنها الآن لأني عايشتها وشهدت أحداثها بأم عيني. وعندما أتحدث عنها مع بعض الأشخاص من جيلي أو أصغر مني أكتشف أنهم ليسوا لديهم أية فكرة عنها. لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله بالنسبة للذاكرة، وبخاصة عدالة الذاكرة.
وعندما سقط ثمانية قتلى في شارون يوم 8 شباط/فبراير عام 1962. كان هناك مليون شخص تقريبا في الشوارع يحتجون. لكن عندما كان الضحايا جزائريين تم اغتيالهم في الشوارع لم يخرج أحد للاحتجاج. لا شيء.
ويجب أن نفرق هنا بين شيئين: سوء تصرف فرنسا في مستعمراتها بوصفها قوة استعمارية، كغالبية الدول الأوروبية الأخرى. وبين سوء تصرفها على أراضيها هي، وهو أمر يزعجني بل ويصدمني. لم أكن حينها إلا مراهقًا في الكشافة لا يعتنق إلا مبادئ التضامن التي تعلمها. لقد صادفت مجزرة في وسط باريس، في ساحة "إيتوال". مشاهد حرب حقيقية.
إن الاعتراف بأن هناك أخطاء غير مقبولة ارتكبت قبل ستين عاما سيكون وسام شرف على صدر الإدارة الفرنسية".
"كنت أحمل رضيعي، وكنت مرعوبة من أن يقتلوه"
جميلة عمران، 87 عامًا. وصل والدها إلى فرنسا عام 1914 عندما تم إجباره على المجيء للعمل في أحد المصانع. ولدت في ضاحية سان دوني الباريسية، ولكن روحها القتالية من أجل استقلال بلادها لم تولد إلا بعد أن سافرت إلى الجزائر. في 17 أكتوبر/تشرين الأول تنزل للتظاهر حاملة بين ذراعيها مولودها الأخير. وربما تدين بحياتها لشخص غريب. بقيت جميلة عمران صامتة بشأن هذه المأساة حتى عام 1987، عندما تم إنشاء رابطة "أفريقيا" المناهضة للعنصرية والداعمة للنسوية، في لا كور نوف. منذ ذلك الحين وهي تناضل حتى لا تقع تلك الليلة في غياهب النسيان.
"لم يكن لنا الحق في الخروج بعد الساعة السادسة مساء. بدا الأمر غير قابل للتصديق بالنسبة لي لأن جميع الجزائريين كانوا يعملون في مصانع مثل رينو، وسيتروين، ودوامهم بين الثالثة والثامنة. وكان الأطفال يتريضون في المساء، ويقوم الآباء والأمهات بالتسوق في ذلك الوقت أيضًا. كان ذلك ظلمًا كبيرًا فرضه بابون.
لذا طلب الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني أن نقوم بمظاهرة سلمية، كنوع من المسيرة البيضاء. وأنا ألح على هذه النقطة لأننا منعنا من أخذ أي سلاح حتى ولو كان دبوسًا.
وشكلنا مجموعة صغيرة من النسوة للذهاب إلى باريس. خرجنا جميعنا مع الأطفال. أخذت رضيعي الأخير، الذي ولد في يوليو/تموز. هبطنا في محطة "بون نوفيل". للأسف، بمجرد وصولنا كانت الشرطة بانتظارنا.
كان طفلي بين ذراعي، كنت خائفة من أن يقتلوه أو تطاله ضربة بالهراوة. كان عمره بضعة أشهر. كان طيش شباب، كنت مجنونة وغير واعية لما كنت أفعله، لم أر الخطر الماثل أمامي. كان الغضب يتفجر بداخلي.
كان طفلي بين ذراعي، كنت خائفة من أن يقتلوه أو تطاله ضربة بالهراوة. كان عمره بضعة أشهر. كان طيش شباب، كنت مجنونة وغير واعية لما كنت أفعله، لم أرى الخطر الماثل أمامي. كان الغضب يتفجر بداخلي.
كان ما أنقذني هو تلك المرأة. فقد فتحت بابًا خشبيا صغيرًا وجذبتني من ذراعي إلى داخل بيتها. وقالت لي: "ماذا تفعلين في الشارع في مثل هذه الساعة يا فتاتي، مع أخيك الصغير بين ذراعيك؟ ألا تدري أمك بما تفعلين!" فأجبت: "لا، إنه طفلي".
يا للجنون، إنني أرى تلك المرأة ذات الشعر الأشقر الآن كما لو كانت هنا أمامي. لم أغادر منزلها إلا بعد ساعة تقريبًا. بفضلها، ربما لم أكن موجودة هنا بينكم اليوم لأروي لكم تلك القصة. لكن ما يؤرقني في الموضوع شيء واحد... أني نسيت أن أسألها عن اسمها في خضم تلك الحرب.
لقد شعرت بالرغبة في استقلال الجزائر عندما زرتها في عام 1954-1955. كنت قد أنهيت دراستي وكنت حرة أكثر بكثير من تلك النسوة. كنت مصدومة لرؤية كل أولئك النسوة الأميات وعاملات المنازل. كن في قاع السلم الاجتماعي. وكن أصغر مني في العمر. لماذا لم يكن لديهن الحق في التعليم؟ لم أفهم أبدًا. الجزائر الفرنسية؟ لم أكن أستطيع فهم الفرق بين هؤلاء الفرنسيين وبيننا نحن الذين كانوا يطلقون علينا "المهاجرين". كان الأمر بمثابة صدمة لي. وترك فيَّ جرحًا لا يندمل. فقلت لنفسي، سأشارك في أي شيء لتغيير الوضع. بمجرد عودتي لفرنسا، بدأت المشاركة في النضال.
لقد مات الكثير من المشاركين في هذه المسيرة. لقد أحاطوا عدد القتلى دائما بالسرية، لكننا نعرف أنهم كانوا كثيرين. كان لدي ابن عم، كان بمثابة أخ لي فأمي هي من ربته، اختفى ولم نره قط. وبعد يومين أو ثلاثة في اجتماع لجبهة التحرير الوطني، علمنا أن هناك عددا كبير من المفقودين.
لم أكن الوحيدة التي لم تتحدث عن 17 أكتوبر/تشرين الأول. لم يعرف أحد أبدًا. حتى أولادي لم يعرفوا إلا بعد زمن طويل. فمن داخلي، كنت أشعر أنني لا أريد معايشة هذا المشهد مرة أخرى. نفس الأمر عندما نشاهد فيلمًا سيئا، لا نرغب في مشاهدته مجددا. لقد دفنته في أعماق أعماقي. كانت ميمونة حجام، رئيسة جمعية "أفريقيا"، هي من ساعدتني على إخراجه. عندما كانت تتكلم عن تلك الأحداث، قلت لها إنني كنت حاضرة فيها أيضا. لم أكن لأتصور أنه سيأتي يوم علي وأتحدث مرة أخرى عن كل ما حدث. فهي ليست بالذكرى الحسنة. كان من الممكن أن أموت يومها أو أفقد حياة رضيعي. وهو الأمر الذي كاد يصيبني بالجنون بعدها.
وعندما بدأت العمل مع جمعية "أفريقيا" كان الناس يسألونني كثيرا: ماذا حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول؟ أي تاريخ هذا؟ هل هو عيد؟ كلا، هناك أناس فقدوا حياتهم في ذلك اليوم. البعض الآخر أشبع ضربا وسيقوا كالبهائم حتى متنزه عام، على ما أذكر كانت غابة فانسين.
لا يجب على الناس أن ينسوا ما فعله الألمان باليهود. فقد أبادوهم. بالنسبة لنا، أريد أن يظل 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 ماثلا في ذاكرتنا وألا ينسى. فهو أمر مهم. بل وينبغي الاعتراف بأنه يوم تاريخي.
نحن الآن في ذكراه "الستين"، إن كان بوسعنا أن نطلق عليه ذلك: "الذكرى". وأنتظر من الدولة الفرنسية اعترافًا بأنها قتلت في ذلك اليوم جزائريين وجزائريات. وأن نتحدث عن هذه الأحداث، في فرنسا أو خارجها، للطلاب من جميع الأعمار، لأنها ويا للأسف لا تزال مجهولة.
ففي كل عام أجتمع مع بعض الأشخاص ممن كانوا حاضرين في ذلك اليوم. أنا لا أفعل ذلك من أجل التكريم. فاليوم، أنا هنا. ولكن غدًا لن أكون. وقريبًا لن يكون هناك أحد ليتحدث عن 17 أكتوبر/تشرين الأول.
أنا لا أنتظر تكريما عندما أتحدث عما حدث. لقد نلت ما أستحق من تكريم على أيدي أبنائي وأحفادي الذين أطلقوا عليَّ لقب "الجدة الشجاعة". فهم يشعرون بالفخر. بيد أني أود أن أرى شيئا يحدث، وأن نحتفي بذلك التاريخ حتى لا تذهب دماء الضحايا سدى. فهو يوم حزين لنا جميعا، ولا ينبغي نسيانه".
"لقد قضيت الليلة في حديقة فانف"
ولد محفوظ الشهير باسم "رحيم" رزيقات في عام 1940 في دوار معديد، في منطقة سطيف في الجزائر. في عام 1948، وبرفقة ثلاثة أشقاء يكبرونه في العمر، انتقل إلى سانت إتيين حيث كان الأخ الأكبر غير الشقيق يدير فندقا هناك. بوصفه عضوًا في جبهة التحرير الوطني، اعتقل عام 1958 وعذب قبل ترحيله إلى معسكرات الاعتقال في لارزاك وتول. أطلق سراحه في عام 1961، لكنه منع من البقاء في إقليمي لو لوار ولو رون، فاستقر به المقام في فانف في ضواحي باريس. في 17 تشرين الأول/أكتوبر، التقى بعدد من الجزائريين في المترو كانوا عائدين من المظاهرة، فقرر العودة أدراجه. اعتقل في مقر إقامته بالفندق بعد بضعة أيام، عانى من سوء المعاملة والإذلال في مركز الفرز بضاحية فانسين. اليوم، أصبح رئيس جمعية "تعزيز الثقافات والترويج للرحلات" (APCV) ومقرها في سان دوني، ويعمل من أجل تخليد ذكرى 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، لا سيما من خلال إلقاء المحاضرات في المدارس الثانوية.
يروي قائلا: "في 17 تشرين الأول/أكتوبر كنت عائدا من عملي في إيسي لي مولينو برفقة صديقي سعد ومجموعة من الجزائريين مقيمين في نفس الفندق. كانت الساعة تشير إلى الخامسة مساءً. طلب منا رئيس خلية جبهة التحرير الوطني التوجه إلى محطة شارل ديغول إيتوال للتظاهر ضد حظر التجول. وكان قد تم فرضه في 5 تشرين الأول/أكتوبر ويحظر جميع تجمعات الجزائريين، أو بالأحرى تجمعات "السمر". وكنت عادة ما يتم توقيفي وتفتيشي.
كانت تعليمات جبهة التحرير الوطني واضحة: يمنع حمل الأسلحة، يجب ارتداء ملابس جيدة ونظيفة لإظهار أننا فخورون بكوننا جزائريين. كانت تلك هي حالتنا النفسية عندما خرجنا إلى الشوارع.
ركبنا المترو من محطة كورنتان-سيلتون. بمجرد وصولنا إلى محطة "بوابة فرساي" قابلنا عددا من الجزائريين الذين صرخوا في وجوهنا "لا تذهبوا إلى هناك". فقد بدأت قوات الأمن في اعتقال العرب.
فعدنا أدراجنا إلى الفندق. وكان يقع في الجهة المقابلة لقسم شرطة فانف. وعندما هبطنا في شارع بيير-سيمار لاحظنا من بعيد أن قوات الأمن وقوات مكافحة الشغب تحاصر الفندق بالفعل.
فتساءلنا أنا وصديقي سعد عما يجب أن نفعل. فذهبنا إلى المقهى. في تمام الثامنة والنصف مساءً، عدنا إلى الفندق لنجد الشرطة لا تزال تحاصره. فاضطررنا لقضاء الليلة في متنزه فانف، الذي كان واقعًا في الجوار. بحلول السادسة صباحًا، ذهبنا إلى أعمالنا في إيسي لي مولينو.
يوم الجمعة التالي داهمت الشرطة فندقنا. كنت مطلًا من النافذة. أطلقوا النار على أحد الأشخاص كان يتوضأ لإقامة الصلاة، فقتلوه. مررنا بليلة رهيبة.
وكان مسموحًا لأفراد الحركى - الذين لا أكن لهم أية كراهية - ومرشدي الشرطة باستخدام العنف. وسمعناهم يصرخون: "هل تريدون الاستقلال؟ سوف نريكم أيها المتمردون القذرون، يا فئران!". ثم سباب متواصل وبصق. كانوا قد أفرغوا غرفة في الجزء الخلفي من الفندق من محتوياتها، وتم نقل جميع الأشخاص الذين يشتبه بهم إليها ليتعرضوا للتعذيب.
وتم نقل جميع نزلاء الفندق، بمن فيهم أنا، إلى مركز الفرز في ضاحية فانسين. وكان ذلك المركز مشهورا بقسوة ظروف الاحتجاز الاحتياطي به ونقل المعتقلين إلى مراكز أخرى أو بطردهم من البلاد. كان هناك صفان من رجال الشرطة ونمر نحن في المنتصف، لذا لن أتحدث عما تلقيناه من ضربات بالعصي أو الركلات أو البصق. لم يكونوا يدعوننا ننام. وكانوا يلقون علينا الماء البارد حتى نبقى مستيقظين.
في اليوم التالي، اتصلوا بي ليخبروني بأنه "يمكنني الذهاب". أصابتني الدهشة، لكنني غادرت على أية حال. في الحقيقة، لم يكونوا على علم بأنني قضيت ثلاث سنوات في معسكرات الاعتقال، وإلا ما كانوا أطلقوا سراحي.
في شهر أغسطس/آب شن هجومان على قوات الشرطة. وحسب جبهة التحرير الوطني، فقد استهدفا المسؤولين عن تعذيب الجزائريين. بعدها، قال بابون: "كل شرطي يقتل، سيسقط في المقابل عشرة جزائريين" (سنرد الضربة بعشرة أمثالها). من الممكن أيضا أن يكون الهدف من هذا القمع هو نسف المفاوضات في إيفيان بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني.
اليوم، أنتظر أن يطلق الرئيس ماكرون على ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول توصيف "جريمة دولة" ويتيح الوصول إلى الأرشيف. أتمنى أيضا أن يعترف، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر العام المقبل، بالاستعمار "كجريمة ضد الإنسانية". لقد كان ذلك أحد وعوده الانتخابية قبل أن يصبح رئيسا.