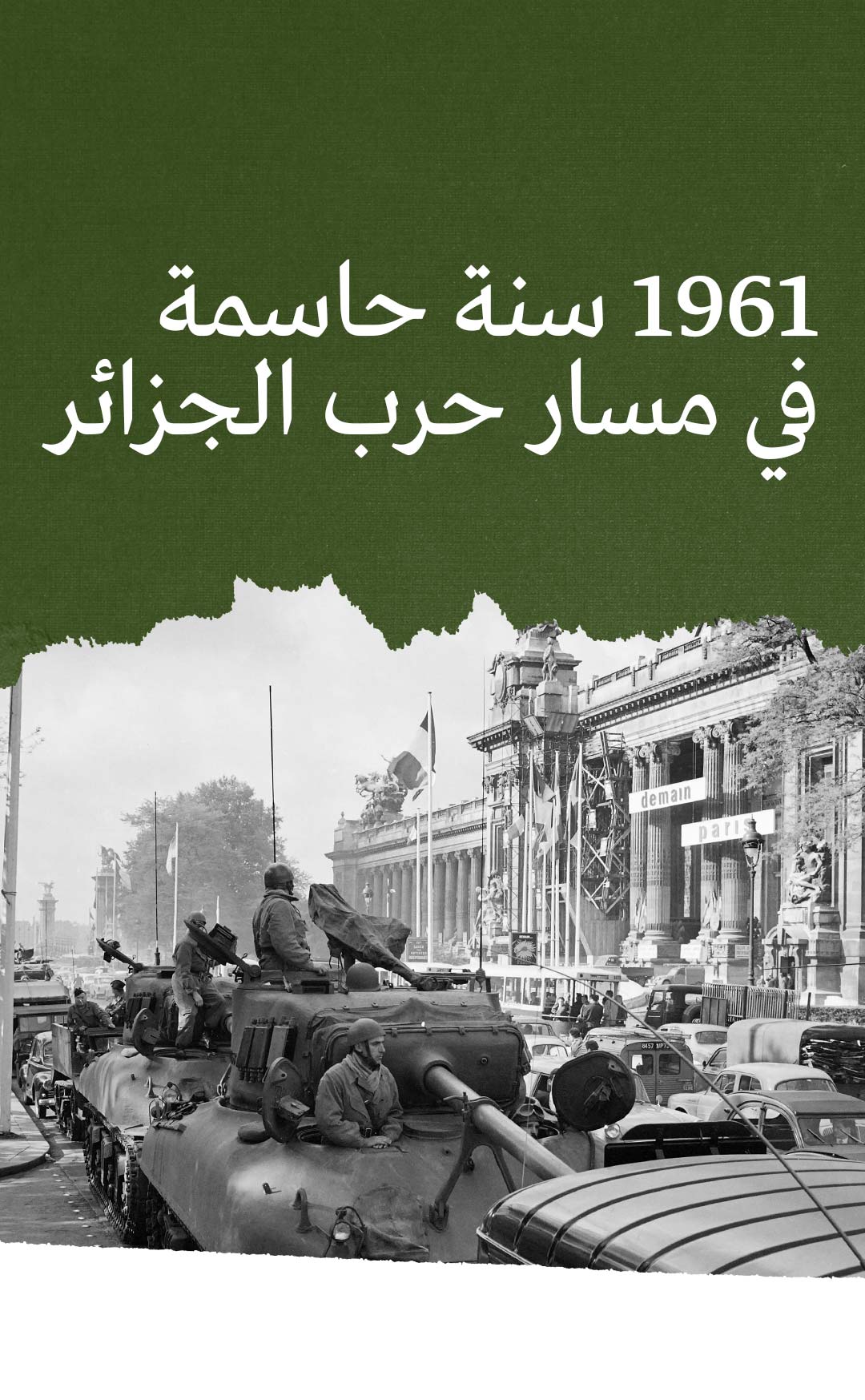كان عام 1961 العام السابع لما أطلق عليه وقتئذ "أحداث الجزائر"، حتى كلمة "حرب" بخلوا بإطلاقها عليها. وهي "الأحداث" التي تسببت في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة وعودة الجنرال شارل ديغول للحكم بوصفه "رئيس المجلس" وذلك بعد الانقلاب الفاشل الذي قام به عدد من العسكريين الفرنسيين يوم 23 مايو/أيار 1958 من أجل تجنب استقلال الجزائر.
وبغض النظر عن شعار "تحيا الجزائر الفرنسية" الذي أطلقه شارل ديغول في 6 حزيران/يونيو، فإن ديغول، الذي بات بعد ستة أشهر أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، كان يدرك جيدًا أن حق الشعب في تقرير مصيره أمر حتمي ولا مفر منه؛ ما دفعه للعمل على وضع حدٍ لهذا الصراع الدامي. وكان الفرنسيون يوافقونه الرأي؛ ففي 8 يناير/كانون الثاني 1961 كانت نتيجة الاستفتاء حول إعطاء الجزائر حق تقرير المصير هي الموافقة بنسبة 75,26 بالمئة. لكن الطريق إلى السلام كان لا يزال زلقًا.
في 11 شباط/فبراير، أسس جان جاك سوسيني وبيير لاغايارد "منظمة الجيش السري" (OAS) في مدريد. وهي منظمة معادية لسياسات الجنرال ديغول، وأراد مؤسسوها الحفاظ على الجزائر فرنسية بأي ثمن، حتى لو استخدموا العنف تحت ذريعة الرد على عنف "جبهة التحرير الوطني". وهكذا وقفت "منظمة الجيش السري" وجهًا لوجه أمام السلطات الفرنسية.
وفي ليلة 21-22 أبريل/نيسان حاول الجنرالات أندريه زيلر وإدمون جوود وراول سالون وموريس شال الاستيلاء على السلطة بالقوة في الجزائر، فيما أطلق عليه "انقلاب الجنرالات". انتهت تلك المحاولة بفشل مطبق بعد أربعة أيام من وقوعها. واعتقل الجنرالان موريس شال وأندريه زيلر بينما فر الجنرالان الآخران وفضلا التخفي ليقودا "منظمة الجيش السري". من الآن فصاعدًا وجهت المنظمة ضرباتها "أينما شاءت ووقتما شاءت".
في مايو/أيار افتتحت فرنسا وحكومة الجزائر المؤقتة (GPRA) ، الذراع السياسية "لجبهة التحرير الوطني" الجزائرية، محادثات رسمية في إيفيان. لكنها توقفت بشكل مفاجئ بعد شهر واحد؛ فالفرنسيون لا يريدون التنازل عن الصحراء، ذات الموقع الإستراتيجي، لكن الجزائريين رفضوا.
سادت إذن أجواء الحرب بين الجانبين في كل مكان وليس على الأراضي الجزائرية فحسب. يقول جيل مونسيرون، مؤلف كتاب "التعمية الثلاثية لمجزرة"، "اعتبارًا من أغسطس/آب 1961، كان هدف معارضي استقلال الجزائر إطلاق عملية قمع عنيفة ضد ’جبهة التحرير الوطني‘ تؤدي إلى تخريب عملية التفاوض". وكان كتاب جيل مونسيرون قد صدر بالتزامن مع كتاب آخر هو "يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول في عيون الجزائريين" للمؤلفين مارسيل وبوليت بيجو. "لكن الجنرال ديغول، الذي كان قد علق المفاوضات عدة أسابيع، رضخ في النهاية وقرر التخلي عن السيادة على الصحراء. وهو ما فتح الباب مجددا لاستئناف المفاوضات".
ويرى مونسيرون أن العودة للمفاوضات لم تكن تروق للجميع بمن فيهم أعضاء الحكومة. "فميشال دوبريه، رئيس الوزراء، وعدد كبير من المسؤولين الآخرين، الذين كانوا قد ساندوا الجنرال ديغول في 13 مايو/أيار 1958، لم يكونوا مؤيدين لاستقلال الجزائر. لذا قام دوبريه، المسؤول عن حفظ النظام في الداخل الفرنسي، بإقالة وزير الداخلية واستبدله بأحد المقربين إليه، روجيه فريه، واحد من صقور "تجمع الشعب الفرنسي". كما كان إلى جانبه أيضا، ومنذ البداية، موريس بابون مدير أمن العاصمة باريس. وبدأت حملة القمع بمداهمات قام بها رجال الشرطة، برفقة قوات الشرطة الموازية وهي المثال الفرنسي لفرق الموت في أمريكا اللاتينية".
بدورها، صعدت "جبهة التحرير الوطني" من ضغوطها على الأراضي الفرنسية، وذلك منذ تعليق محادثات إيفيان، عن طريق مضاعفة هجماتها، وبخاصة في قلب باريس. واستهدفت خصوصًا قوات حفظ النظام، رمز سلطة الدولة.
"وتحولت باريس إلى ساحة حرب. وأحاطت أقسام الشرطة مبانيها بالأسلاك الشائكة، وأبراج حراسة من الكتل الخرسانية"، كما يقول المؤرخ المتخصص في تاريخ الشرطة في فرنسا جان مارك برليير. "وقتل في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني 1958 ونهاية عام 1961، 47 رجل شرطة وأصيب 137 آخرون تابعون لمديرية الأمن".
مديرية أمن العاصمة باريس... "دولة داخل الدولة"
وقتئذ، كانت مديرية الأمن مستقلة تماما عن الشرطة الوطنية. "فقد فشلت حكومة فيشي في إدماجها في الشرطة الوطنية. لذا تحولت لدولة داخل الدولة"، كما يقول جان مارك بيرليير مشددًا على أنها "كانت تضم وحدها عددًا كبيرًا من رجال الشرطة يفوق عدد أفراد الشرطة الوطنية. وعادةً ما يقال إن مدير الأمن أقوى كثيرًا من وزير الداخلية لأن تحت إمرته الآلاف من رجال الشرطة في عاصمة الدولة".
هذا الرجل هو موريس بابون. بعد عودته من الخدمة في الجزائر عام 1958، قرر بابون تشديد الإجراءات القمعية عبر تطبيق الأساليب التي تعلمها في الجزائر أثناء عمله في قسنطينة. وزادت بشكل مكثف عمليات التحقق من الهوية في صفوف من يطلق عليهم إداريًا "مسلمو فرنسا الجزائريون".
فأمسكت إذن بزمام الأمور الشرطة المساعدة، المؤلفة من جنود مسلمين من الجزائر الفرنسية (الحركى) وتأسست عام 1959 بمبادرة من رئيس الوزراء ميشال دوبريه، وباتت مسؤولة عن التصدي للاتحاد الفرنسي التابع "لجبهة التحرير الوطني" (FLN). يوضح جان مارك برليير بالقول: "كان لهم ثأر مع’ جبهة التحرير الوطني‘بسبب التعذيب أو القتل والقمع الذي عانوا منه هم أو عائلاتهم علي يد الجبهة". "وسيظهرون وحشية مماثلة في تعاملهم مع أفرادها". وبدأ عناصرها ينفذون عمليات مداهمة وإعدامات وتحقيق تحت التعذيب. وكانت شمس كل يوم تشرق على عدد من جثث الجزائريين الطافية في نهر السين، كما يؤكد فابريس ريسبوتي مؤلف كتاب "هنا أغرقنا الجزائريين".
ويتابع فابريس بقوله: "في هذا العهد في فرنسا، ساد نوع من العنصرية الاستعمارية وقع الجزائريون بخاصة ضحية لها، وكان وقتئذ شائعًا أن تمارس الشرطة عنفًا شديدًا دون أن تتعرض للعقاب، وذلك بالطبع بمساعدة مؤسسات الجمهورية: قادة الشرطة الذين يغضون الطرف عن ممارسات جنودهم، والسلطة القضائية التي لا تلاحق أحدًا، والصحافة التي لا تستحي من نشر الأكاذيب".
في خريف 1961 أخذت الأحداث منحىً متسارعًا. وبات الجميع متوترا. وبعد كل عملية إرهابية يشعر عناصر الشرطة بالإحباط أكثر فأكثر. يقول جان مارك بيرليير: "من آب/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر عام 1961، قتل ثمانية من رجال الشرطة في باريس". "وبدأ الشعور بالغضب يجتاح رجال الشرطة. كما تضاعفت التهديدات بالإضراب أو التظاهر وصولًا إلى العصيان الكامل في صفوفهم. وباتت السلطة الحاكمة مشلولة. فهي من جهتها لا تود تكرار إضرابات رجال الشرطة ومظاهراتهم التي جرت في 13 آذار/مارس عام 1958 وعجلت بسقوط الجمهورية الرابعة".
وطالبت نقابات الشرطة باتخاذ تدابير قوية وفعالة. وهو ما لقي سريعًا آذانا صاغية. "سنرد الضربة بعشرة أمثالها". هكذا صرخ موريس بابون في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 1961 في جنازة أحد ضباط الشرطة. بل ذهب بعيدًا في تشجيعه رجال الشرطة إلى أن يكونوا البادئين بإطلاق النار.
ويضيف بيرليير: "وبما أن رجال الشرطة كانوا بالفعل في مرمى نقد نشطاء منظمة الجيش السري، فقد قرر موريس بابون وميشال دوبريه وروجيه فريه اتخاذ تدابير تحافظ على ولائهم للدولة، ومن هذه التدابير حظر التجول الذي كان وراء أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول".
في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، وقع موريس بابون مرسومًا يفرض حظر التجول على شريحة واحدة من المواطنين: مسلمو فرنسا الجزائريون.
"ومن أجل وضع حد فوري للأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإرهابيون، اتخذت مديرية الأمن تدابير جديدة لتوها. ولوضع قراره موضع التنفيذ، وجهت نصائح على وجه السرعة للعمال الجزائريين بألا يجولوا ليلًا في شوارع العاصمة الفرنسية باريس أو ضواحيها، وتحديدا بين الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الخامسة والنصف صباحًا. وعلى من تفرض عليهم ظروف عملهم التنقل خلال هذه الساعات، تقديم طلب إلى قطاع المساعدة الفنية في حييهم أو في دائرتهم بالحصول على شهادة تمنح لهم بعد التأكد من طلبهم. من جهة أخرى، كان قد لوحظ أن العمليات الإرهابية ترتكبها في غالب الأحيان مجموعة مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد. ولذلك، أوصي المسلمين الفرنسيين بالتجوال فرادى، وإلا تعرضت المجموعات الصغيرة من الرجال للاشتباه الفوري من قبل رجال الشرطة. ونهاية، أصدر مدير الأمن أوامر للمحال والمقاهي التي تقدم المشروبات للمسلمين الفرنسيين بالإغلاق يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً".
ودخل ذلك القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي.

17 أكتوبر/تشرين الأول، "معركة باريس"
وبالطبع لم يكن الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني مستعدًا لالتزام الصمت تجاه قرار حظر التجول. إضافة إلى كونه قرارًا تمييزيًا من الطراز الأول، فإنه يعوق بشكل كبير أداء المنظمة. فقد كانت الاجتماعات السرية وجمع الأموال لتمويل المعارك في الجزائر تجري جميعها في المساء. وكان واضحاً لقادة جبهة التحرير الوطني أن الرد يجب أن يكون جماعيا وسلميا قبل كل شيء.
وبأكبر قدر من التكتم، نظمت الجبهة مسيرة ضد هذا الإجراء الاستثنائي ألا وهو قمع الشرطة. ووجهت الدعوة للجزائريين، رجالا ونساءً وأطفالا للنزول إلى شوارع باريس في 17 أكتوبر/تشرين الأول عند بدء حظر التجول.
"كانت مظاهرة سلمية وغير مسلحة، فقد خرج الجزائريون إلى الشوارع انتهاكًا لقرار حظر تجول لا يخص أحدًا غيرهم"، كما يقول جيل مونسيرون مشددا على أن هذا الحظر كان "غير دستوري من وجهة نظر القيم الجمهورية والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون".
بالنسبة لجان مارك برليير فإنه كان لجبهة التحرير الوطني، المنهكة من التطاحن بين أجنحتها، هدف داخلي من هذه المظاهرة: "الحصول على بعض المكاسب لمن يقاتلون على الأرض، الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني، والذين يجمعون الضريبة الثورية ويقومون بالعمليات الفدائية ويتعرضون لقمع قوات الأمن. فالسلطة لن تكون لهم على أية حال مع إنهم هم من قام بالأعمال القذرة؛ بل ستكون لأولئك الذين يقبعون في الظل في تونس وألمانيا". وحسب رأي هذا المؤرخ "فإن الفكرة وراء 17 أكتوبر/تشرين الأول هي أن يكون هناك شهداء وقتلى من أجل المطالبة بمكان في الجزائر المستقبلية. المشكلة الوحيدة هي أنهم لم يكونوا يعرفون أنه سيكون هناك إغلاق كامل لباريس. فإطلاق الأطفال والنساء في الشوارع بمواجهة رجال الشرطة الغاضبين مما كان يحدث لهم، تتحمل جبهة التحرير بعض المسؤولية عنه، وهو أمر نغفل الحديث عنه".
علمها المسبق بهذه الدعوة السرية، مكن مديرية الأمن من معرفة كافة تفاصيل سير الخطة. فما كان من موريس بابون إلا أن قرر إحاطة المدينة بنقاط التفتيش لمنع تدفق الجزائريين على باريس أو الاقتراب منها. على أية حال، ما كان يجب لهذه التظاهرة أن تجري.
يوم الثلاثاء، 17 أكتوبر/تشرين الأول، ونحو الساعة السادسة مساءً، قدم بين 20 و30 ألف جزائري من الأحياء الفقيرة والبلدات الصناعية في الضواحي ومن أحياء مختلفة أيضا من العاصمة، وبدأوا يتدفقون سواء بالقطارات أو في مترو الأنفاق أو حتى سيرا على الأقدام على قلب العاصمة. وكانت الأوامر الموجهة لهم في غاية الوضوح: "لا تحملوا أية أسلحة وتجنبوا الاستفزاز".
وكان من المقرر لبعض المواكب أن تتجه جنوبا إلى جادة سان ميشال بين ساحة الجمهورية وساحة الأوبرا وإلى جادة الشانزليزيه الشهيرة. لكن قوات الأمن كانت قد أغلقت بالفعل مداخل المدينة مثل جسر نويي. وانتشر نحو 1600 من رجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب في النقاط الساخنة ولا سيما عند مخارج المترو في ساحات إيتوال وأوبرا وكونكورد. وكانوا مدججين بالأسلحة من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم... رشاشات وبنادق وهراوات ومسدسات أتوماتيكية... إلخ. .
"علينا أن نتخيل الحالة النفسية لرجال الشرطة. كانت كراهية العرب مستشرية، وكان يطلق عليهم’ البطيخ‘"، كما يقول جان مارك برليير. "وكان عدد كبير منهم قد خدم في الجزائر من قبل. وعندما سمعوا بأن الجزائريين سيطلقون مسيرة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، غمرتهم السعادة، فقد حان وقت الانتقام أخيرًا".
وبدأت قوات الأمن في التدخل على أرصفة المترو واعتقال المتظاهرين وضربهم. وعلى جسر سان ميشيل بدأت قوات الشرطة في الهجوم. وأطلق العنان للعنف في كل مكان.
ومن أجل زيادة التوتر في صفوفهم، انتشرت الإشاعات الكاذبة بسرعة. مثل أن العديد من الجزائريين المسلمين مدججين بالسلاح، وأن عددًا من ضباط الشرطة قد قتلوا. وهذا على أية حال ما تؤكده شهادة رجل شرطة نشرت في مجلة الإكسبريس عام 1997. "جاء أحد زملائنا، مسؤول الراديو، ليقول لنا ’يا رجال، ستجتمع الفئران - كنا ننعتهم بالفئران - على جادة الشانزليزيه... يبدو أنهم سيهاجمون قسم شرطة الدائرة الثامنة"، هكذا روى راوول لوتار الذي كان ضابطًا شابًا آنذاك. ثم قال من بعد: "لقد حاصر الفئران عددًا من رجالنا" في هذه اللحظة حدث ما لم يتوقعه أحد... كان الموت يتربص في كل مكان... فأخرج كل واحد منه’ حقيبة الهراوات‘... وبدأ يخرج أشدها فتكًا..."
يقول إيمانويل بلانشار، مؤلف "17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس، تظاهرة جزائرية ومجزرة استعمارية"، إن "هذه التأكيدات الزائفة تظهر إلى أية درجة كان مركز القيادة في ليل دو لا سيتيه (مديرية أمن العاصمة - المحرر) كان يسير بمنطق معاكس تمامًا لمنطق ’حفظ النظام‘".
وكان المتظاهرون الموقوفون يرحلون في حافلات استولت عليها الشرطة من شركة نقل ركاب العاصمة (RATP) إلى مراكز اعتقال: قصر الرياضة على بوابة فرساي، استاد كوبرتان وحتى مستشفى بوجون القديم. أكثر من 11 ألف من مسلمي فرنسا الجزائريين اعتقلوا في تلك الليلة.
وتعرض بعضهم للضرب حتى الموت، وقتلوا ضربًا بالعصي والهراوات، أو أطلق عليهم النار. وألقي البعض الآخر في نهر السين، أحياء أو أمواتا، وأحيانا مقيدين أو غير مقيدين. "غرقى بالرصاص" حسب التعبير غير الرسمي الذي أطلقته مديرية الأمن. وخلال عدة أيام من بعد المجزرة، كانت أجسادهم طافية على سطح الماء في النهر أو في القنوات المتفرعة عنه.

الحصيلة المستحيل تصديقها
ومع ذلك، في بيانها الصحفي، ذكرت مديرية الأمن أن حالتي وفاة فقط قد سجلتا على جسر نويي خلال “تبادل لإطلاق النار" بين الشرطة والمتظاهرين "الذين أجبروا على المشاركة في المظاهرة بعد تهديد جبهة التحرير الوطني لهم" و44 حالة إصابات. ثم زادت حصيلة القتلى لتبلغ ثلاثة أشخاص وإصابة 64 آخرين، وذلك بعدها بعدة أيام. وفي صفوف الشرطة؟ لا ضحايا. بيد أن موريس بابون قال إن "عشرة على الأقل من رجال الشرطة قد نقلوا إلى المستشفى".
بينما أعلنت جبهة التحرير الوطني عن سقوط 200 قتيل و2300 مصاب واختفاء 400 شخص.
بعد ثلاثين عاما، في 1991، نشر جان لوك إينودي تحقيقًا عنوانه "معركة باريس، 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961". وذكر في هذا التحقيق، الأول من نوعه عن هذه الأحداث، أن 200 جزائري قد لقوا حتفهم جراء عنف الشرطة في ذلك اليوم وأن 325 آخرين قد قتلوا بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
وفي مايو/أيار 1998، عدَّل سكرتير الدولة دودونيه ماندلكيرن الحصيلة الرسمية التي وصلت إلى 32 قتيلا، وذلك في تقرير رسمي أمر بكتابته وزير الداخلية آنذاك جان بيير شوفينمون واستند إلى وثائق الشرطة الأرشيفية وسجلات دخول معهد الطب الشرعي في باريس. بعدها بعام، واستنادا إلى المحفوظات القضائية، قدَّر القاضي جان جيرونيمي عدد الجزائريين الذين غرقوا في نهر السين في ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، بنحو 48 شخصًا وذلك في تقرير رسمي طلبته وزيرة العدل إليزابيت غيغو. وهو رقم عده أدنى من العدد الواقعي. فقد كتب: "من المحتمل جدا أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، فليس من المؤكد أنه تم العثور على جميع الجثث الغارقة، وهي كثيرة في ذلك الوقت، كما أنه من الممكن أيضا أن يكون التيار قد جرف الجثث إلى أبعد من ذلك في مجرى نهر السين، ربما حتى منابع إيفرو أو روون، فالوثائق المحفوظة تشوبها الكثير من العيوب ولا يمكن الخروج منها بمعلومات صحيحة".
في العام 1999، قدر جان بول برونيه العدد بنحو 30 إلى 40 قتيلا، وهو أحد المؤرخين النادرين الذين كان لهم الحق في الاطلاع على أرشيف الشرطة. ويعتبر أن تقدير عدد القتلى على يد الشرطة بمئة هو "خيالي أكثر من اللازم"، فهذا الرقم قد يكون ربما عدد الجزائريين الذين "اغتالتهم" جبهة التحرير الوطني لعدم دفعهم المستحقات المالية أو لانصرافهم عن تأييد قضية الاستقلال.
وإن كانت الحصيلة في ذلك اليوم محل خلاف، فإن العديد من المؤرخين يتفقون أن عدد القتلى بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول يتراوح بين 100 و300 قتيل. "وفيما يخص 17 أكتوبر/تشرين الأول، فباستطاعتنا تقدير عدد القتلى بنحو 150، أو أكثر من 100 على الأقل"، كما يقول فابريس ريسبوتي. "الكثير من المؤرخين يعدون 17 أكتوبر/تشرين الأول الذروة في سلسلة طويلة من الأحداث يصنفها جيم هاوس ونيل ماكمستر "بإرهاب الدولة". وتمتد من شهر أغسطس/آب، عندما شنت جبهة التحرير الوطني هجماتها على أفراد الشرطة والجيش الفرنسيين، وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وطوال تلك الفترة لم يتوقف جمع الجثث من نهر السين. من المحتمل إذن أن الرقم 300 هو عدد القتلى الإجمالي خلال هذه الفترة بأكملها. والرواية الرسمية زائفة وكاذبة بصورة شنيعة".
فرض ستار حديدي على أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول
في صباح 18 أكتوبر/تشرين الأول، كان التعتيم هو سيد الموقف. أو تقريبًا. فالراوية الرسمية تجد لها موطئ قدم: الجزائريون دفعوا دفعا للتظاهر بضغط من جبهة التحرير الوطني، وبعضهم باشر بإطلاق النار. واضطرت الشرطة للرد دفاعا عن النفس. بينما اقتنعت الصحافة - ومن ضمنها اليسارية -، المفروض عليها الرقابة أساسًا في زمن الحرب هذا، بالرواية الرسمية. وبالتالي قبل بها الناس.
وواصلت الشرطة، خلال عدة أيام لاحقة، احتجاز متظاهرين في قصر الرياضة تحديدًا في فرساي. فيما أعيد البعض الآخر للجزائر وفرضت عليهم الإقامة الجبرية. "وهناك ما بين ألف أو ألفين - لا نعرف على وجه الدقة - قد طردوا من البلاد. وهو ما كان يطلق عليه وقتئذ "إعادتهم إلى مسقط رأسهم". لكنهم وضعوا في معسكرات. فماذا حدث لهم؟"، يتساءل جيل مونسيرون موضحًا أن الحصيلة قد يعاد فيها النظر بالازدياد.
ورغم الرقابة المفروضة عليها، بدأت الصحافة تهتم بالوقائع. وكان إيلي كاغان واحدًا من المصورين القلائل الذين تجولوا في شوارع باريس في تلك الليلة والتقطوا عنف رجال الشرطة. وصور رجالًا موقوفين على أرصفة محطات المترو أيديهم مقيدة خلف ظهورهم أو مرفوعة في الهواء ووجوههم للحائط في حين يقف خلفهم رجال شرطة مسلحين بالرشاشات. صور كذلك رجالًا مصابين أجسادهم مغطاة بالدماء. وكذلك قتلى.
رفضت العديد من الصحف نشر صور إيلي كاغان، لكنها نشرت أخيرًا في 27 أكتوبر/تشرين الأول في صحيفة "الشهادة المسيحية".
بعد ذلك بعدة أسابيع، حاولت الصحفية بوليت بيجو نشر كتابها "وحشية في شوارع باريس". وهو الكتاب الذي صادرته الشرطة القضائية سريعًا. وهناك أيضًا فيلم وثائقي للمخرج جاك بانيجل عنوانه "أكتوبر الباريسي" الذي بدأ تصويره غداة الأحداث ومنع من البث في عام 1962.
وها قد بدأت الحناجر في الهتاف. ولكن بخجل. ورفضت البلاغات المقدمة من أسر المفقودين. على الجانب السياسي، ارتفع عدد قليل من الأصوات. وعندما كان البعض منها يبدأ في الحديث، مثل المستشار الباريسي كلود بورديه أو النائبين البرلمانيين غاستون دوفير وأوجين كلاوديوس-بتيت، كانوا يواجهون بالنفي من جهة الحكومة أو من جهة مدير الأمن موريس بابون. ولم تشكل أبدًا أية لجنة للتحقيق في الأحداث. وأصدرت العديد من مراسيم العفو عن أعمال حفظ النظام في فرنسا، ومنع الوصول إلى الوثائق المحفوظة، ناهيك عن اختفاء عدد من الصناديق، كما يقول فابريس ريسبوتي في "هنا أغرقنا الجزائريين".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، قال موريس بابون أمام مجلس باريس منتشيًا: "لقد كسبنا معركة باريس!".
وساد صمت هائل. دام أكثر من ثلاثين عامًا. وكان ذلك بداية التعمية.